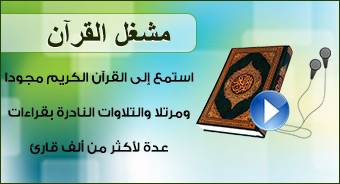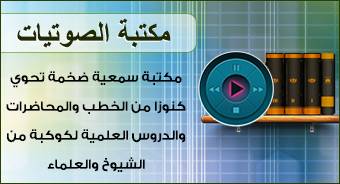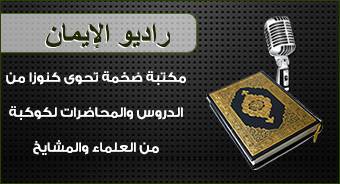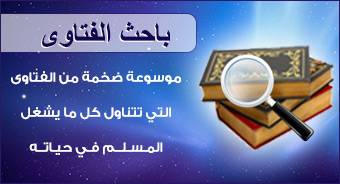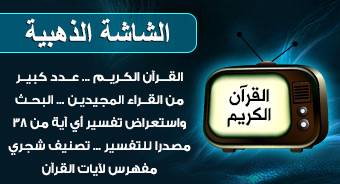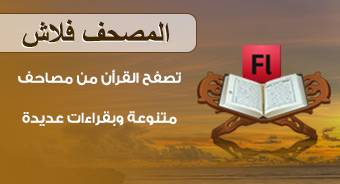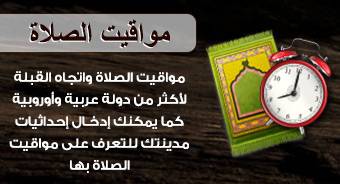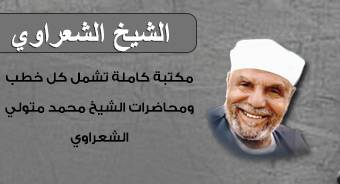|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
أي كأني وضعتُ الرجل على ثورِ وحْششٍ أحَسَّ بأنسيّ وهو منفردٌ عن قطيعه.وهو صفة مشبهة مثل حَسَن، يقال: وَحُد مثل كرُم، ووَحِدَ مثل فرِح.وصيغة الصفة المشبهة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتيٌّ له، فلذلك أوثر {أحد} هنا على (واحد) لأن (واحد) اسم فاعل لا يفيد التمكن.ف (واحد) و{أحد} وصفان مصوغان بالتصريف لمادة متحدة وهي مادة الوحدة يعني التفرد.هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ (أحد)، أشهرها أنه يستعمل اسمًا بمعنى إنسان في خصوص النفي نحو قوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} في البقرة (285)، وقوله: {ولا أشرك بربي أحدا} في الكهف (38) وكذلك إطلاقه على العدد في الحساب نحو: أحد عشر، وأحد وعشرين، ومؤنثه إحدى، ومن العلماء من خلط بين (واحد) وبين {أحد} فوقع في ارتباك.فوصف الله بأنه {أحد} معناه: أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه العلَم وهي الإلهية المعروفة، فإذا قيل: {اللَّه أحد} فالمراد أنه منفرد بالإلهية، وإذا قيل: الله وأحد، فالمراد أنه وأحد لا متعدد فمَن دونه ليس بإله.ومآل الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى في إلهيته.فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليمًا للناس كلهم، وإبطالًا لعقيدة الشرك وُصف الله في هذه السورة بـ: {أحد} ولم يوصف بـ: (واحد) لأن الصفة المشبهة نهايةُ ما يُمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي المبين.وقال ابن سينا في تفسير له لهذه السورة: إن {أحد} دالّ على أنه تعالى وأحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلًا لا كثرةً معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول، ولا كثرة حسيّة وهي كثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلًا كما في المادة والصورة.والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم، وذلك متضمن لكونه سبحانه منزهًا عن الجنس والفصل، والمادة والصورة، والأعراض والأبعَاض، والأعضاء، والأشكال، والألوان، وسائر ما يُثلم الوحدة الكاملة والبَساطة الحَقَّة اللائقة بكرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء.وتبيينُه: أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك، والذي لا ينقسم بوجه أصلًا أولى بالوحدانيَّة مما ينقسم من بعض الوجوه، والذي لا ينقسم انقسامًا عقليًّا أوْلَى بالوحدانية من الذي ينقسم انقسامًا بالحسّ بالقوة ثم بالفعل، ف {أحد} جامع للدلالة على الوحدانية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة في موصوفه. اهـ.قلت: قد فهم المسلمون هذا فقد روي أن بلالًا كان إذا عذب على الإِسلام يقول: أحد أحد، وكان شعار المسلمين يوم بدر: أحد أحد.والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن {أحد} ليس ملحقًا بالأسماء الحسنى لأنه لم يرد ذكره في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة».وعدّها ولم يذكر فيها وصف أحد، وذكر وصف وأحد وعلى ذلك درج أمام الحرمين في كتاب (الإِرشاد) وكتاببِ (اللمع) والغزالي في (شرح الأسماء الحسنى).وقال الفهري في (شرحه على لُمع الأدلة) لأمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى: {الواحد}. وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم.ودرح ابن بَرَّجَان الإِشبيلي في (شرح الأسماء) والشيخ مُحمد بن محمد الكومي (بالميم) التونسي، ولُطف الله الأرضرُومي في (معارج النور)، على عدّ (أحد) في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الْوَاحد فقالا: الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء تسعة وتسعين، وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتضضِ حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين، وإنما هو لبيان فضيلة تلك الأسماء المعدودة فيه.والمعنى: أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات.وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل الشرك، وللتثليث الذي أحدثه النصارى المَلْكانية وللثانوية عند المجوس، وللعَدَد الذي لا يُحصى عند البراهمة.فقوله: {اللَّه أحد} نظير قوله في الآية الأخرى: {إنما الله إله وأحد} [النساء: 171].وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة الله، أي حقيقته فابتدئ لهم بأنه وأحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية في شيء.ثم إن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والدُّهريين.وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى الأحدية لأنه إذا كان منفردًا بالإلهية كان مستغنيًا عن المخصِّص بالإِيجاد لأنه لو افتقر إلى من يُوجده لكان من يوجده إلها أوَّلَ منه فلذلك كان وجود الله قديمًا غير مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصص بالوجُود بدَلًا عن العدم، وكان مستعينًا عن الإمداد بالوجود فكان باقيًا، وكان غنيًا عن غيره، وكان مخالفًا للحوادث وإلا لاحتاج مثلَها إلى المخصص فكان وصفه تعالى: بـ: {أحد} جامعًا للصفات السلبية.ومثلُ ذلك يُقال في مرادفه وهو وصف وَأحد.واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة، فالله تعالى وأحد من جميع الوجوه، وعلى كل التقادير فليس لكُنْه الله كثرة أصلًا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقوّمات من الأجناس والفصول التي تتقوم منها المواهي، ولا كثرةُ الأجزاء في الخارج التي تتقوم منها الأجسام.فأفاد وصف {أحد} أنه منزه عن الجنس والفصل والمادة والصورة، والأعراض والأبعاض، والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة كما إشار إليه ابن سينا.قال في (الكشاف): وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم {اللَّه أحد} بغير {قل هو}. اهـ، ولعله أخذه مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ: {اللَّه أحد} كان بِعَدْل ثلثثِ القرآن، كما ذكره بأثر قراءة أبيّ بدون {قل} كما تأوله الطيبي إذ قال: وهذا استشهاد على هذه القراءة.وعندي إن صح ما روي من القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الامتثال لما أمر بأن يقوله، وهذا كما كان يُكثر أن يقول: «سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي» يَتأول قوله تعالى: {فسبح بحمد ربك واستغفره} [النصر: 3].{اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} جملة ثانية محكية بالقول المحكية به جملة: {اللَّه أحد}، فهي خبر ثان عن الضمير. والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله، وإنما فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجملة مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غيرَ ملحقة بالتي قبلها بالعطف، على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول: الحوزُ شرط صحة الحُبس، الحوز لا يتم إلا بالمعانية، ونحو قولك: عنترة من فحول الشعراء، عنترة من أبطال الفرسان.ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله: {اللَّه الصمد} وكان مقتضى الظاهر أن يقال: هو الصمد.و{الصَمد}: السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات، وهو سيد القوم المطاع فيهم.قال في (الكشاف): وهو فَعَل بمعنى مفعول من: صَمَد إليه، إذا قصده، فالصمد المصمود في الحوائج.قلت: ونظيره السَّند الذي تُسند إليه الأمور المهمة.والفَلَق اسم الصباح لأنه يتفلق عنه الليل.و{الصمد}: من صفات الله، والله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه العموم.فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي.ومعناه: المفتقر إليه كلُّ ما عداه، فالمعدوم مفتقر وجودُه إليه والموجود مفتقر في شؤونه إليه.وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد، وكلها مندرجة تحت هذا المعنى الجامع، وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا.ويشمل هذا الاسمُ صفاتتِ الله المعنويةَ الإِضافية وهي كونه تعالى حيًّا، عالمًا، مريدًا، قادرًا، متكلمًا، سميعًا، بصيرًا، لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصمودًا إليه.وصيغة {اللَّه الصمد} صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة الصمدية على الله تعالى، وهو قصر قلب لإِبطال ما تعوّده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نَسُوا الله.قال أبو سفيان ليلة فتح مكة وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله» لقد علمتُ أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئًا.{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولد (3)} جملة: {لم يلد} خبر ثانٍ عن اسم الجلالة من قوله: {اللَّه الصمد}، أو حال من المبتدأ أو بدل اشتمال من جملة {اللَّه الصمد}، لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجزه، ولذلك استدل على إبطال قولهم: {اتخذ اللَّه ولدا} بإثبات أنه الغنيّ في قوله تعالى: {قالوا اتخذ اللَّه ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات الأرض} [يونس: 68] فبعدَ أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدد الإله بالأصالة والاستقلال، أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله، لأن المتولد مساوٍ لما تولد عنه.والتعدُّد بالتولد مساوٍ في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا اللَّه لفسدتا} [الأنبياء: 22] (وهو برهان التمانع) ولأنه لو تولد عن الله موجود آخر للزم انفصال جزء عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية كما علمت آنفًا وبَطل اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بنات الله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك، لأن البنوّة للإله تقتضي إلهية الابن قال تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26].وجملة {لم يولد} عطف على جملة {لم يلد}، أي ولم يلده غيره، وهي بمنزلة الاحتراس سدًّا لتجويز أن يكون له والِد، فأردف نفي الولد بنفي الوالد.وإنما قدم نفي الولد لأنه أهم إذ قد نَسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والِدًا.وفيه الإِيماء إلى أن من يكون مولودًا مثل عيسى لا يكون إلها لأنه لو كان الإله مولودًا لكان وجوده مسبوقًا بعدم لا محالة، وذلك محال لأنه لو كان مسبوقًا بعدم لكان مفتقرأ إلى من يُخصصه بالوجود بعد العدم، فحصل من مجموع جملة: {لم يلد ولم يولد} إبطالُ أن يكون الله والدًا لِمولود، أو مولودًا من والد بالصراحة.وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة (زرادشت) الثانوية القائلة بوجود إلهين: إله الخير وهو الأصل، وإله الشر وهو متولد عن إله الخير، لأن إله الخير وهو المسمى عندهم (يزدان) فكَّر فكرةً سوء فتولد منه إله الشر المسمى عندهم (أهرُمنْ)، وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله: وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا يكون إلاّ إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن لله، وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودًا بعد عدم.فالمولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكون عيسى إلها.فلما أبْطَلَت الجملةُ الأولى إلهية إله غير الله بالأصالة، وأبْطَلَتْ الجملة الثانية إلهية غير الله بالاستحقاق، أبْطَلَت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية.وإنما نفي أن يكون الله والدًا وأن يكون مولودًا في الزمن الماضي، لأن عقيدة التولد ادعت وقوعَ ذلك في زمن مضى، ولم يدع أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل.{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحد (4)}في معنى التذييل للجمل التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحَها وكنايتها وضمنيَّها لا يشبهه فيها غيره، مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فيما عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى: {إن الذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له} [الحج: 73].والواو في قوله: {ولم يكن له كفؤًا} اعتراضية، وهي واو الحال، كالواو في قوله تعالى: {وهل يجازى إلا الكفور} [سبأ: 17] فإنها تذييل لجملة {ذلك جَزَيْنَاهم بما كفروا} [سبأ: 17]، ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة فيكون المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى التذييل تبعًا للمعنى، والنكت لا تتزاحم.والكُفُؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره.وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر، إلا أن الثلاثة الأولين حَققوا الهمزة وأبو جعفر سهَّلها ويقال: (كُفْء) بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمز، وبه قرأ حمزة ويعقوب، ويقال: {كفوًا} بالواو عوض الهمز، وبه قرأ حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة.ومعناه: المساوي والمماثل في الصفات.و{أحد} هنا بمعنى إنسان أو موجود، وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيّز النفي.وحصل بهذا جناس تام مع قوله: {قل هو الله أحد}.وتقديم خبر (كان) على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكُفؤ عقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع.وتقديم المجرور بقوله: {له} على متعلَّقه وهو {كفؤًا} للاهتمام باستحقاق الله نفي كفاءة أحد له، فكان هذا الاهتمام مرجحًا تقديم المجرور على متعلَّقه وإن كان الأصل تأخير المتعلَّق إذا كان ظرفًا لغوًا.وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتض التقديمَ مقتضضٍ كما أشار إليه في (الكشاف). وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون.وثبت في الحديث الصحيح في (الموطأ) و(الصحيحين) من طرق عدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «{قل هو اللَّه أحد} تعدل ثلث القرآن».واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الآثار لهذا الحديث ويجمعها أربعة تأويلات:الأول: أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة، أي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونها حتى لو كررها القارئ ثلاث مرات كان له ثواب من قرأ القرآن كله.الثاني: أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سورة القرآن.الثالث: أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني لأنّ معاني القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإِسلامية ما لم يجمعه غيرها.وأقول: إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي، أو لأنه لا توجد سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص.التأويل الرابع: أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة.قال ابن رشد في (البيان والتحصيل): أجمع العلماء على أن من قرأ: {قل هو اللَّه أحد} ثلاثَ مرات لا يساوي في الأجر من أحَيَا بالقرآن كله. اهـ.فيكون هذا التأويل قيدًا للتأويل الأول، ولكن في حكايته الإِجماع على أن ذلك هو المراد نظر، فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل قراءة ختمة كاملة.قال ابن رشد: واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الإِشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض.وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. اهـ.
|